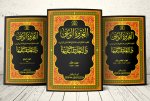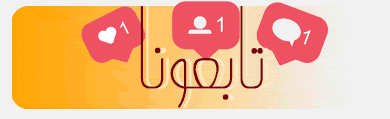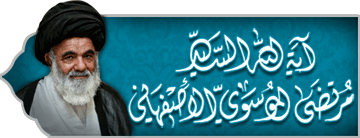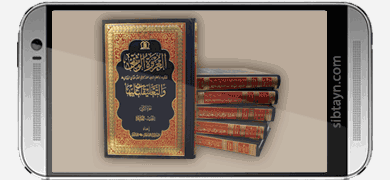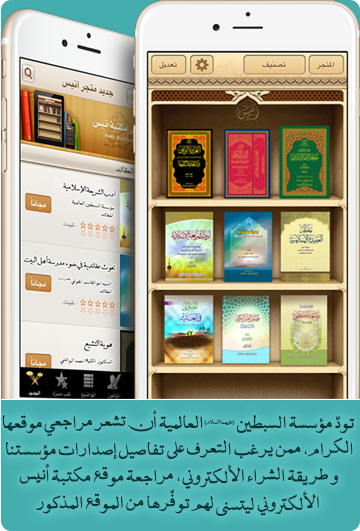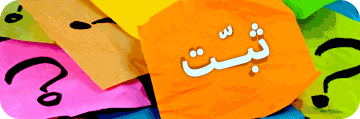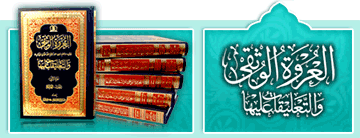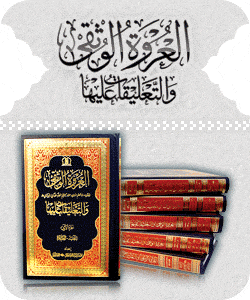شعراء «الخوارج»:
لقد عرف من «الخوارج» خطباء وشعراء، ولا سيما في الصدر الأول، حيث إن أكثر قوادهم كانوا من البدو، من جند الكوفة والبصرة(1)، وكان الإنسان البدوي يمتاز بالفصاحة في منطقه، ويمتلك قدرات تعبيرية يمتاز بها عن غيره من سائر الناس.
الأرجاز في شعر «الخوارج»:
وحيث إنهم قد اتخذوا طريق العنف، والحرب وسيلة لتحقيق أهدافهم السياسية، فإن الرجز في الحرب يصبح ضرورة لهم، لأجل تشجيع الجبان، ومكابدة الحرب والطعان. ولأجل ذلك فإن غالب ما قالوه من الشعر قد جاء في وصف الحرب، وفي التشجيع على خوض غمارها، مادام أن حياتهم كانت تتخذ الطابع الحربي في غالب مقاطعها، وتميز شعرهم بكثرة الأرجاز فيه(2).
وهذا هو الطابع الذي يطبع أدب أهل البادية بشكل عام..
ولاسيما حين يواجه فرسانهم الأقران في ساحات الحرب والنزال.
شعراؤهم من العرب والموالي:
ورغم كثرة من نطق بالشعر فيهم، وكونهم من القبائل والفرق المختلفة؛ فإننا نلاحظ: أنهم لا يهاجمون الفرق الخارجية الأخرى، ولا كانوا يذكرون عقائد وخصائص فرقهم هم أنفسهم. بل إن شعرهم يكاد يكون لوناً واحداً.
وقد كان الذين قالوا شعراً من «الخوارج» ينتمون إلى قبائل عربية مختلفة باستثناء قريش(3).
وذكروا: أن لهم شعراء من الموالي أيضاً، مثل حبيب بن خدرة، الذي كان من موالي بني هلال(4).
وعمرو بن الحسن الإباضي، وهو من موالي الكوفة(5).
وعمرو بن الحصين، أحد موالي بني تميم(6).
وزياد بن الأعسم، الذي قيل: إنه من بني عبد القيس، أو من مواليهم(7).
ولكننا بدورنا: لا نجد لدى هؤلاء ما يستحق أن يجعل أياً منهم جديراً بأن يصنف أو يكون في عداد الشعراء، فإن وجود بعض المقطوعات لهم هو أمر عادي جداً في المجتمع العربي، الذي يكثر فيه أمثال هؤلاء.
نعم يمكن أن يعد عمران بن حطان من شعرائهم، رغم تجاهل الأدباء له، ولعله لأنهم لم يروا في شعره ما يستحق أن يجعله يصنف في عداد الشعراء أيضاً.
كيف يرى المؤلفون أدب «الخوارج»:
وقد أفاض الكتاب والمؤلفون في تسطير الآراء التي يقترب بعضها من الحقيقة، بينما يهاجر بعضها عنها مغاضباً لها، ليستقر في أعماق الخيال والأوهام، غير آسف على شيء؛ لأنه آثر أن يعتصم بصوامع المجهول، وينعم بزيف الغي والجهالة إلى غير رجعة..
ونحن نذكر هنا: بعضاً من ذلك، مما ظهر فيه الخلط بين الحق والباطل، والمزج بين الواقع والخيال، فنقول:
1ـ قد وصف البعض شعر «الخوارج» بقوله: «.. إنه شعر ثورة جامحة. محوره الأنا، ونحن. وإطاره المذهب الخارجي. وغايته فراديس السماء»(8).
ونحن لا نوافقه على قوله: «شعر ثورة جامحة» ونقول: بل هو شعر البدوي، الذي يعتمد على سيفه ورمحه لنيل ما يطمح إليه، حقاً كان أو باطلاً. ولا يعتمد على المنطق، والبرهان.. ولا ينطلق من دواعي الضمير والوجدان، ولا تقيده الروادع الدينية والإيمانية.. فلا يمكن أن نعتبر هذا السلوك الطبعي المتأصل في الأعراب الغارقين في بحار الجهل والهوى.. أنه ثورة، أو أنه إحساس وجداني نبيل.
ونرفض أيضاً: أن تكون غاية ذلك الشعر هو فراديس السماء.. فإن الله لم يطلع هذا القائل على غيبه، ليقرأ في قلوب أولئك الشعراء غاياتهم ونواياهم..
وإذا كان الشعر مبنياً على التبجح، والادعاء، والمبالغة..
ثم إذا كان «الخوارج» ـ كما ظهر من فصول هذا الكتاب بالنصوص والأرقام ـ طلاب دنيا، ورواد حكم، يبحثون عن ذلك بكل خف، ويسعون له بكل حافر وظلف.
وإذا كانوا أيضاً لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء في سبيل ذلك، حتى الكذب على رسول الله (صلوات الله وسلامه عليه) وآله، فكانوا إذا أحبوا شيئاً صيروه حديثاً..
فهل يمكن بعد هذا استكشاف نواياهم، وغاياتهم من شعرهم الذي ينشدونه في مواقع المواجهة؟! حيث يهيمن الغرور، وتستيقظ العنجهيات.
أضف إلى ذلك: أن أهم ما يجذب الناس إلى «الخوارج» هو إدعاؤهم أنهم ملتزمون لخط الشريعة، ومتصلبون في الدين. فلماذا لا يستخدمون هذا الأمر في إعلامهم من أجل ذلك أيضاً.. بهدف إثارة الحماس لدى السذج والبسطاء من الذين لم يطلعوا على حقيقة نوايا قادتهم وزعمائهم؟!
2ـ ثم إن ثمة نصاً آخراً، يقول: «يمكن القول: إن الشعر عند شعراء الفرق الخارجية ـ بشكل عام ـ كان إما تسجيلاً لأعمال حربية، أو رثاء لقتلاهم ـ ترغيباً أو ترهيباً»(9).
«ولعل الظاهرة العامة الأخرى، التي تطغى على شعر «الخوارج»: أنه جاء في أكثره يخاطب المشاعر، والوجدان، دون أن يعمد إلى مخاطبة العقل والمنطق؛ لإعطاء الحجة المقبولة، والبرهان العقلي لما ينادون به، فكان عملهم أشبه ما يكون بعمل الصحافيين، الذين يعمدون إلى إلهاب عواطف الناس، واستثارة حماس جماهير العوام، بالكلمات المؤثرة، والشعارات المثيرة.
ولا ننسى مدى فعالية هذا الأسلوب على جماعة «الخوارج» الذين كانوا بأكثريتهم الساحقة، من الأعراب، والقراء المتدينين»(10).
وهذا الكلام: وإن كان في أكثره معقولاً ومقبولاً، لكن لنا تعقيب على العبارة الأخيرة، فإن تدينهم، لم يكن قائماً على أسس فكرية، وقناعات حقيقية، وإنما هي ظواهر ومظاهر ألفوها، ووجدوا فيها سبيلاً إلى الحصول على بعض ما عجزوا عن الحصول عليه بالأساليب الأخرى؛ وقد أخبر النبي الأعظم (صلى الله عليه وآله): أنهم يقرأون القرآن، ولا يجاوز تراقيهم. وأنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقد دلت ممارساتهم على ما نقول فلا حاجة إلى الإعادة.
مبالغات لا مبرر لها:
ثم إن بعض الكتاب: قد زعم.. أن للخوارج أدباً له طابع مميز، وخصائص معينة، تنسجم مع واقع الحياة، ومع المفاهيم التي كانوا يعيشونها، فقد كانت لديهم نفوس بدوية، تملك سرعة الخاطر، والقدرة على البيان، بأوجز عبارة وأقوى لفظ، إلى جانب ذلك تحمس، وصراحة، وعاطفة، وليس في أدبهم أثر للخمر والمجون، وإنما فيه القوة والصلابة، والجمال، والقتال، وهو أدب لساني، لا أدب مكتوب، بل هو خطب وشعر، وبديهة واحتجاج(11).
وقالوا أيضاً: «هذه الصفات، أعني الشدة في الدين والإخلاص للعقيدة، والشجاعة النادرة، يضاف إليها العربية الخالصة هي التي جعلت للخوارج أدباً خاصاً يمتاز بالقوة، شعراً ونثراً، تخيّر للفظ، وقوة في السبك، وفصاحة في الأسلوب»(12).
ونقول: إن هذا الوصف المتنوع لشعرهم مفرط في المبالغة، ولا يعبر عن الحقيقة.. وهو ظاهر الخلل، بيِّن الزيف والخطل.
فلاحظ ما يلي:
1ـ قوله: إن لأدب «الخوارج» طابعاً مميزاً، وخصائص معينة.. ليس بذي قيمة، لأن «الخوارج» إذا كانوا أعراباً جفاةً، يطغى عليهم الجهل، والهوى، والبداوة، فإن شعرهم سوف يكون حتماً شعر الأعراب الجفاة، الذي يفقد الطراوة، ولا يملك صوراً خلابة، ولا خيالاً رائعاً ومثيراً.
2ـ إننا لم نجد في شعر «الخوارج» ذلك الجمال الذي ادعاه، بل هو شعر تقريري يقتصر على ألفاظ عادية ومتداولة. ولا يقدم أية صورة شاعرية، تحمل شيئاً من الإبداع والجمال اللافت..
3ـ لا نجد للخوارج احتجاجاً قوياً ولا مؤثراً، ولاسيما في مقابل أمير المؤمنين (عليه السلام) وأصحابه الأخيار والأبرار. بل كانت احتجاجات غيرهم هي التي تؤثر فيهم، فيتراجعون عن مواقفهم بالمئات والألوف..
وأما حين يواجهون الأمويين فإنهم لا يحتاجون امتلاك قدرة احتجاجية خاصة، بل يكفي ذكر وسرد مثالب بني أمية، التي يمكن أن يقوم بها أضعف الناس فيستطيل بها على أبرع الناس في الاحتجاج..
4ـ وأما الخطب.. فإن سرد مخازي بني أمية يكفي أضعف الناس عن أي خطاب، لكننا نجد في المقابل أن أصحاب أمير المؤمنين (عليه السلام) كانوا هم مضرب المثل في ذلك، حيث يضرب المثل بصعصعة بن صوحان في ذلك، فقيل: «أخطب من صعصعة بن صوحان إذا تكلمت الخوارج».
أما أمير المؤمنين (عليه السلام) فقد ردهم بكلامه الحلو في غير موطن حسبما اعترفوا به هم أنفسهم كما تقدم.
5ـ أما بعض العبارات المتميزة التي تنسب لبعض زعمائهم.. فيجدها الباحث المتتبع في ثنايا كلام أمير المؤمنين (عليه السلام)، فهي إما مسروقة منه (عليه السلام)، منحولة لغيره.. وإما أن «الخوارج» أنفسهم كانوا يحفظونها عنه، وقد استفادوا منها في خطبهم، فأعطتها قوةً ورونقاً..
وما أكثر الغارات على كلمات أمير المؤمنين (عليه السلام)، وخطبه، وفضائله وكراماته كما لا يخفى على الباحث الأديب، والمتتبع اللبيب..
6ـ وأما بالنسبة للصراحة، فإن من بيده السيف قادر على أن يتكلم بما يشاء.. ولكن حين يقع السيف من يده، فإنك تجده يستعمل التقية في القول وفي الفعل بإغراق شديد. وبإمعان بالغ، كما كان الحال بالنسبة للخوارج.
7ـ وأما الإخلاص للعقيدة، فقد ذكرنا الكثير مما يدل على أن أمر الدنيا كان هو الأهم عندهم، والأولى بنظرهم.
8ـ وعن شجاعتهم النادرة ذكرنا أيضاً، ما يكذب الشائعات التي أعطتهم صورة الشجعان الأتقياء، والبررة الأوفياء..
9ـ ويضحك الثكلى حديثه عن: «تخير للفظ، وقوة في السبك». فإننا لم نجد في شعرهم إلا عفوية البدوي الجاهل، الذي يبتدر الكلام بما تيسر له من ألفاظٍ يلتقطها مما يجده في طريقه، وهو على عجلة من أمره..
وحسبنا ما ذكرناه: فإننا لا نريد أن نفسح المجال للذين يحاولون أن يتبرعوا بأوسمة الاتهامات الجاهزة، ليخلعوا علينا حللاً منها موشّاةً بالتعصب لتعصب المذهبي تارة، أو الاتهام بالانطلاق من أفكار عنصرية أخرى، أو ما إلى ذلك..
دعاوى أخرى حول أدب «الخوارج»!!
يقول البعض: «إذا كان شعر الخوارج ونثرهم، يمثلان أصدق تمثيل حياتهم الحربية، وأحاسيسهم الوجدانية، وعواطفهم الدينية، وآمالهم العريضة؛ فإن هذه الآثار الأدبية قد فشلت فشلاً تاماً في إعطاء صورة واضحة للفكر الخارجي، أو للعقائد الخارجية السياسية منها والدينية، هذا إذا استثنينا ما يستخلص من مزاعمهم: نحن الإسلام، والإسلام نحن».
ولعل هذه الظاهرة تخالف ما عهدناه عند معاصريهم من الفرق الإسلامية الأخرى؛ فإن الشعر الشيعي، يسجل لنا بوضوح مبادئ الشيعة، وعقائدهم، على اختلاف نظرياتهم.
وكذلك الحال عند المرجئة: «فإن لثابت قطنة قصيدة أودعها مختلف آراء هذه الفرقة وعقائدها..»(13) انتهى.
ونقول: من أين للخوارج الفكر العقائدي والسياسي، الذي يمكن التعبير عنه في الأدب والشعر، وهم إنما كانوا في بادئ أمرهم أصحاب أطماع، وسفاحين، ثم انتهى أمرهم إلى أن أصبحوا لصوصاً سلابين.
وإن كان لدى بعضهم حب للوصول إلى الحق، فإن جهود هؤلاء لم تنته إلى نتيجة ظاهرة، فإنهم بعد أن اتبعوا غير سبيل الصالحين، بتخليهم عن إمامهم، ثم محاربتهم له، واصرارهم على البراءة منه، وتكفيره، قد تاهوا في خضم الشبهات، ثم وقعوا في فخ أصحاب الطموح والأطماع، حركتهم ـ كما بدأت ـ حركة عدوانية طامعة في الحصول على شيء من حطام الدنيا..
وقد بقوا غارقين في مشاكلهم مع الآخرين، يهيمن عليهم الجهل، والأعرابية، ويسيرهم الهوى؛ فلم يكن لديهم علماء يهذبون لهم أفكارهم، ويحددون لهم مذاهبهم، ويهتمون بإعطائها صفة معقولة ومنسجمة، إلا بعد أن مضت المئات من السنين، وقد كان ذلك في مستويات بدائية ضحلة، وغير ناضجة..
فمحاولة مقايستهم بالشيعة وحتى بالمرجئة تصبح محاولة فاشلة، ليس لها ما يبررها.
ويقول البعض: «.. ولعل ما يلفت النظر بشأن شعراء الفرق الخارجية، أن شعر كل جماعة منهم جاء متناسباً مع حجم الأعمال العسكرية، التي قامت بها كل منها؛ فالأزارقة كثر شعرهم الحربي؛ تسجيلاً لبطولاتهم، وانتصاراتهم الحربية؛ لان وجودهم كان سلسلة متصلة من المعارك المتواصلة.
والصفرية قل شعرهم الحربي، لأن اكثرهم مال إلى القعود.
ولكن يبدو أن الرواة قد حالوا بيننا وبين ما قيل في تصوير انتصارات شبيب الحروري الأسطورية.
أما النجدية: فإن الخلافات المبكرة في صفوف زعمائهم حالت بينهم وبين الأعمال الحربية العظيمة المستمرة، فقل شعرهم بذلك.
والإباضية: لم نسمع لهم شعراً إلا بعد أن قاموا بمحاولاتهم الجدّية للاستيلاء على بلاد الحجاز، واليمن، وما دونهما»(14).
خلاصة الرأي في أدب «الخوارج»:
ونقول:
إن ما يقال عن وجود حياة أدبية ذات قيمة لدى «الخوارج» لا يمكن قبوله على إطلاقه، فإن غاية ما يمكن أن يقال هنا هو: إنه قد ظهرت منهم في حروبهم أو في غيرها بعض المقطوعات، النثرية والشعرية، التي جاء أكثرها حماسياً، ولكن لم يكن فيها الكثير من الجمال والإبداع، بحيث يهتم بتدوينها هواة الشعر والأدب، وجامعوه في كتبهم ومصادرهم.
ولأجل ذلك نلاحظ: أن أبا الفرج والمسعودي لم يوردا إلا النزر اليسير من أخبارهم الأدبية، كما أن ابن قتيبة لم يأت على ذكرهم في كتابة الشعر والشعراء، إلا بشأن سرقات الطرماح من الشعراء الآخرين، بينما ابن سلام لا يرى احداً منهم يستحق التصنيف في طبقاته(15).
وإذا كانت الكتب التاريخية، وهي تسجل لنا تاريخ «الخوارج» قد أوردت ما أنشأوه في مواقفهم المختلفة، فإن ذلك قد جاء رعاية لأمانة النقل، وحفاظاً على تناسق الأحداث.. لا لأنها كانت تمتاز بجمال لافت، استحقت لأجله التسجيل.
وقد حاول البعض: إرجاع عدم وجود رواية لمقطوعات أدبية بكثرة لهم، في ما بأيدينا من كتب الأدب وغيرها إلى تعمد الرواة، والمؤرخين تجاهل ذلك. وهو الأمر الذي نشأ عنه ضياع نتاجهم الأدبي، فلم يصلنا إلا القليل من شعرهم(16).
وقد رأوا: أن هذا التعمد يرجع ـ كلاً أو بعضاً ـ إلى الأسباب التالية:
1ـ إن اللعنات التي انصبت على «الخوارج»، عامة قد انعكست على آثارهم الأدبية، فاضطهدهم الرواة والمؤرخون، وأهملوا إنتاجهم وتركوه نهباً للضياع(17).
2ـ إن بعض المؤرخين قد يكون قد أهمل شعر «الخوارج» كرهاً لهم.
3ـ أو تجنباً لإثارة خصوم «الخوارج» عليهم.
4ـ إن «الخوارج» لم يتخذوا الشعر حرفة للتكسب، فلم يحرصوا على روايته وإثباته.
5ـ إن سيطرة القرآن ووجدانهم عليهم قد حال بينهم وبين الاهتمام الزائد بفنّ الشعر.
6ـ إن موت العديد من الشعراء في الحروب المتواصلة كان سبباً لضياع أكثر شعرهم، لأن أبرز شعرائهم كانوا هم فرسانهم الذين قتلوا(18).
ونقول:
إن نفس ذلك الشخص الذي ذكر ما تقدم قد أجاب على النقاط الثلاث الأولى. فلا حاجة إلى الحديث عتها.
وأما بقية النقاط فنحن نشير فيما يرتبط بها إلى المناقشات التالية:
1ـ «إن آخرين منهم [أي من الرواة والمؤرخين] أبدوا اهتماماً زائداً بشعرهم. وأخبارهم أيضاً؛ فلم يتحرجوا من نقل أخبار بطولاتهم الحربية، وشجاعتهم النادرة؛ فهذا ما نلحظه في كامل المبرد، وتاريخ الطبري، وأنساب البلاذري، وغيرها من المصادر القديمة.
2ـ يضاف إلى ذلك: أن جمع الأدب وتسجيله، قد تم في فترة زمنية لم يكن فيها للخوارج شأن خطير، ولا شوكة ظاهرة. وفي وقتلم يجد فيه بعض المؤرخين حرجاً في إثبات روايات أبي عبيدة، معمر بن المثنى، الخارجي، اليهودي الأصل(19).
فلا يصح بعد هذا أن يعمم الحكم؛ فيقال: إن أخبار «الخوارج» قد طمست، وإن أشعارهم قد دفنت.
3ـ فالرواة الذين نقلوا إلينا أعنف افتراء على علي بن أبي طالب (عليه السلام)، في مديح عمران بن حطان لابن ملجم، لا يتحرجون في نقل ما هو أخف حدّةً، وأقل عنفاً»(20).
4ـ وأما دعوى: أنهم لم يحرصوا على إثبات شعرهم، لكونهم لم يتخذوه للتكسب.
فهي غير وجيهة؛ إذ قد رأينا أن المؤرخين قد أثبتوا جميع أنواع الشعر، ورووه، بل إن رواية الشعر الذي يقال: إنه لغير التكسب أدعى، وأولى بالإثبات، سواء بالنسبة لصاحب الشعر، أو بالنسبة لغيره ممن تصدى من الناس للرواية وللكتابة.
5ـ وحول سيطرة القرآن على وجدان «الخوارج»، حتى صرفهم ذلك عن الاهتمام الزائد بفن الشعر، نقول: إن هذا الكلام يستبطن إنكار أن يكون للخوارج أدب وشعر من الأساس..
أضف إلى ذلك: أنها دعوى يكذبها ما ثبت عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) في وصف «الخوارج»، من أنهم يقرؤون القرآن، ولا يجاوز تراقيهم(21).
فإن معنى ذلك هو أنه لا سيطرة للقرآن على وجدانهم، فلا تأثير له إذن على موقفهم من الأدب والشعر، لا سلباً ولا إيجاباً..
6ـ ثم إن ما ذكر أخيراً من أن شعراءهم إنما كانوا فرسانهم، وقد قتلوا في الحروب؛ فذلك هو سبب عدم نقل شعرهم إلينا..
لا يصح أيضاً، إذ أن الشعر إنما يرويه الآخرون عنهم، ممن سمعه منهم. وقد عاش هؤلاء الفرسان: الشعراء (حسب الفرض) إلى حين قتلوا ـ عاشوا ـ بين المئات والألوف من الناس، فلماذا يختفي شعرهم فقط، ولا يختفي شعر الكثيرين من الفرسان، الذين أكلتهم الحروب، وقد خلدها عنهم الرواة والمؤرخون.
إلا أن يكون المقصود بالشعر الذي لم ينقل هو تلك الأرجاز التي تأتي على البديهة في ساحة الحرب والنزال، وهي جهد ضئيل، لا يكاد يصل إلى درجة أن يصبح حياة أدبية لطائفة واسعة الانتشار في طول البلاد الإسلامية وعرضها.
صعصعة.. و«الخوارج»!!
ولابد من التذكير هنا بحقيقة أن كل خطب «الخوارج»، وكل أراجيزهم الحماسية، لم تستطع أن تصمد أمام المنطق القوي، والبليغ، والحازم الذي كان يواجههم به اصحاب أمير المؤمنين (عليه الصلاة والسلام)، ولاسيما صعصعة بن صوحان العبدي، الرجل الفذ، الذي جمع إلى بلاغة المنطق، صواب القول، وسطوع الحجة، فبهرهم بذلك، وأعجزهم عن مجاراته، حتى أصبحت مواقفه معهم مثلاً سائراً في الناس.
يقول الجاحظ: «إن أشيم بن شقيق، بن ثور، قال لعبد الله بن زياد، بن ظبيان: ما كنت تقول لربك ـ وقد حملت رأس مصعب بن الزبير إلى عبد الملك بن مروان؟!
قال: أسكت، فأنت يوم القيامة أخطب من صعصعة بن صوحان، إذا تكلمت الخوارج»(22).
وقد بلغ من تأثير خطب صعصعة: أنه وعظهم مرةً، فرجع منهم خمس مئة، فدخلوا في جملة علي وجماعته(23).
بل يذكر طه حسين: أن صعصعة وعظهم؛ فرجع منهم ألفان(1) ولعل ذلك كان في مناسبة أخرى له معهم.
وقال البلاذري: «.. فبعث إليهم عليٌّ، ابن عباس، وصعصعة، فوعظهم صعصعة وحاجهم ابن عباس، فرجع منهم ألفان»(24).
من خطب ومواقف صعصعة مع «الخوارج»:
وقد ذكر المفيد: ((رحمه الله)) أحد مواقف صعصعة مع «الخوارج»، وهو يدل على ثبات قدم صعصعة في مجال الخطابة والوعظ، وعلى قوة عارضته، ثم على ثباته في عقيدته، وثاقب فكره، ووعيه.
يقول النص المحكي عنه: لما بعث علي بن أبي طالب (صلوات الله وسلامه عليه) صعصعة إلى «الخوارج» قالوا له: أرأيت لو كان علي معنا في موضعنا، أتكون معه؟!
قال: نعم.
قالوا: فأنت إذاً مقلد علياً دينك!! إرجع فلا دين لك.
فقال لهم صعصعة: ألا أقلد من قلد الله فأحسن التقليد؛ فاضطلع بأمر الله صديقاً لم يزل؟! أو لم يكن رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا اشتدت الحرب قدمه في لهواتها؛ فيطأ صماخها بأخمصه، ويخمد لهبها بحدّه، مكدوداً في ذات الله، عنه يعبر رسول الله (صلى الله عليه وآله) والمسلمون؛ فأنى تصرفون؟ وأين تذهبون؟ وإلى من ترغبون؟ وعمّن تصدفون؟ عن القمر الباهر؟ والسراج الزاهر، وصراط الله المستقيم، وحسان الأعد(25) المقيم. قاتلكم الله أنى تؤفكون؟ أفي الصديق الأكبر، والغرض الأقصى ترمون؟ طاشت عقولكم، وغارت حلومكم، وشاهت وجوهكم. لقد علوتم القلة من الجبل، وباعدتم العلة من النهل.
أتستهدفون أمير المؤمنين (صلوات الله عليه)، ووصي رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟ لقد سوّلت لكم أنفسكم خسراناً مبيناً. فبعداً وسحقاً للكفرة الظالمين، عدل بكم عن القصد الشيطان، وعمى لكم عن واضح المحجة الحرمان.
فقال له عبد الله بن وهب الراسبي: نطقت يا بن صوحان بشقشقة بعير، وهدرت فأطنبت في الهدير. أبلغ صاحبك أنا مقاتلوه على حكم الله والتنزيل.
فقال عبد الله بن وهب أبياتاً. قال العكلي الحرماوي: ولا أدري أهي له أم لغيره:
نقاتلكم كي تلزموا الحق وحده ونضربكم حتى يكون لنا الحكم
فإن تبتغوا حكم الإله نكن لكم إذا ما اصطلحنا الحق والأمن والسلم
وإلا.. فإن المشرفية محذم بأيدي رجال فيهم الدين والعلم
فقال صعصعة: كأني انظر إليك يا أخا راسب مترملاً بدمائك، يحجل الطير بأشلائك، لا تجاب لكم داعية، ولا تسمع لكم واعية، يستحل ذلك منكم إمام هدى. قال الراسبي:
سيعلم الليث إذا التقينا دور الرحى عليه أو علينا
أبلغ صاحبك: أنا غير راجعين عنه، أو يقر لله بكفره، أو يخرج عن ذنبه، فإن الله قابل التوب، شديد العقاب، وغافر الذنب؛ فإذا فعل ذلك بذلنا المهج.
فقال صعصعة: عند الصباح يحمد القوم السُّرى.
ثم رجع إلى علي (صلوات الله عليه)، فأخبره بما جرى بينه وبينهم إلخ(26).
فالراسبي لم يجب صعصعة إلا بالشتم والإهانة، ولم يكن لديه حجة، ولا دليل منطقي يبرر به ما يقدم عليه.. بل هو حتى لم يقابل الموعظة، بالموعظة ولا النصيحة بالنصيحة، بل أعلن عن أطماعه الدنيوية بالوصول إلى الحكم، وأن يكون لهم دون غيرهم. ونجد صعصعة يقدم صوراً رائعة من البلاغة، والوعي، والعقلانية، والغيرة على مصلحة الأمة، والعمق العقيدي القائم على أساس قوي، ومتين وعلى الرؤية الواضحة.
وفي نص آخر: أنه لما فارقت «الخوارج» علياً (عليه السلام)، ونزلوا حروراء مع ابن الكواء بعث علي (عليه السلام) إليهم ابن عباس، وصعصعة.
فقال لهم صعصعة: إنما يكون القضية من قابل؛ فكونوا على ما أنتم حتى تنظروا القضية كيف تكون.
قالوا: إنما نخاف أن يحدث أبا [كذا] موسى شيئاً يكون كفراً.
قال: فلا تكفروا العام مخافة عام قابل.
فلما قام صعصعة، قال لهم ابن الكواء: «أي قوم، ألستم تعلمون أني دعوتكم إلى هذا الأمر؟
قالوا: بلى.
قال: فإن هذا ناصح فأطيعوه»(27).
هفوة ظاهرة:
ولا حاجة بنا إلى التعريف بصعصعة، ووفائه الظاهر لامير المؤمنين (عليه السلام) إلى أن مات، ودفاعه عن قضيته (عليه السلام) في قبال «الخوارج» وغيرهم بكل ما أوتي من قوة وحول. فإن ذلك من بديهيات التاريخ التي لا يرقى إليها أدنى شك أو شبهة.
ولكننا: ـ مع ذلك ـ نجد الجوزجاني يعد صعصعة بن صوحان بالذات في جملة «الخوارج» الذين نبذ الناس حديثهم اتهاماً لهم(2) فاقرأ ذلك واعجب ما بدا لك، فإنك ما عشت أراك الدهر عجباً.
____________
(1) دائرة المعارف الإسلامية ج8 ص476 وراجع: الخوارج في العصر الأموي ص296.
(2) الخوارج في العصر الأموي ص292.
(3) الخوارج في العصر الأموي ص250.
(4) البيان والتبيين ج3 ص261.
(5) معجم الشعراء للمرزباني ص229.
(6) الأغاني ج20 ص102.
(7) عن أنساب الأشراف ج7 ص118.
(8) الخوارج في العصر الأموي ص292.
(9) المصدر السابق ص252.
(10) المصدر السابق ص286.
(11) راجع: ضحى الإسلام ج3 ص344 و345.
(12) فجر الإسلام ص264.
(13) الخوارج في العصر الأموي ص253/254.
(14) الخوارج في العصر الأموي ص252.
(15) الخوارج في العصر الأموي ص253/254.
(16) الخوارج في العصر الأموي ص253/254.
(17) القاضي النعمان في كتابه: الفرق الإسلامية في الشعر الأموي ص406 نقلنا ذلك عنه بواسطة كتاب: الخوارج في العصر الأموي ص253/254..
(18) الخوارج في العصر الأموي ص254 فما بعدها.
(19) أحال هذا القائل هنا على كتاب: وفيات الأعيان ج4 ص227.
(20) الخوارج في العصر الأموي ص254.
(21) تقدمت مصادر هذه الرواية في أوائل الكتاب، فراجع.
(22) البيان والتبيين ج1 ص326/327 وذكر المعتزلي هذا النص في شرحه للنهج ج3 ص398، لكنه لم يذكر الخوارج، ونص عبارته هكذا: [إن تركت أحتج، كنت أخطب من صعصعة بن صوحان].
(23) أنساب الأشراف [بتحقيق المحمودي] ج2 ص354.
(24) في بعض النسخ: وسبيل الله المقيم.
(25) الإختصاص ص121/122.
(26) لسان الميزان ج3 ص329 عن يعقوب بن شيبة.
(27) أحوال الرجال ص35.
الفصل الخامس: أدب الخوارج
- الزيارات: 1472